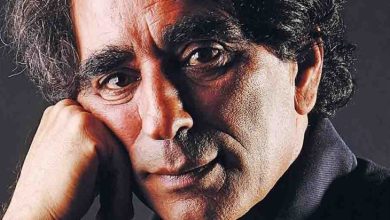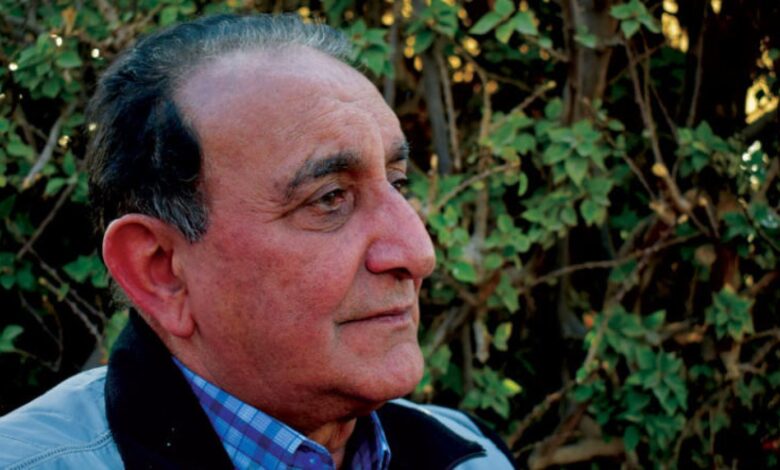
أحاول في هذه المقالة أن أشرك القارئ في مراجعة التحقيق النقدي الذي قدّمه الناقد والأكاديمي عبد اللطيف الوراري (ثقافة – القدس العربي 12 -7-2024) بعنوان “لماذا تراجع نقد الشعر؟”.
ورغم كوني من المسهمين في الإجابات المنشورة على تساؤلات الوراري، وددت تنشيطاً للموضوع وأهميته تناول الأفكار التي خرجتُ بها من قراءة إجابات الزملاء وتداعياتها، ومقدمة الوراري الضافية التي تستحق المراجعة بما ركزتْ عليه ولخصتْ تشخيصه من علل وتعليلات، لاسيما ربطه التساؤل عن تراجع نقد الشعر وخفوته، بأزمة الشعر ذاتياً وموضوعياً.
وبذلك لم يقع في تكرار شكوى الشعراء المزمنة حول التقصير النقدي، أو الجهر بالاستغناء عنه وتهميش دوره. وأكثر ما لفتني في المقدمة بجانب التركيز على أزمة النقد الشعري، التذكير بطرف الثنائية الآخر، أي الشعر الذي لا يرى الشعراء غالباً ما يمر به من تراجع، أو يغفلون تمحيص واقع الشعرية العربية وأزمتها التي وُفّق الوراري في تعيين بعض سماتها، لا سيما التداولية منها، مثل ما أسماه (خفوت الشعر) وهجرة الشعراء إلى فنون مجاورة، أرى أن لها قاعدة أوسع في القراءة، والانغماس في المظاهر التقبلية المحايثة؛ كالمسابقات والجوائز. بجانب الطلب الشحيح لاقتناء الكتب الشعرية فضلاً عن النقدية، والذي يعلنه الناشرون دوماً وهم يرصدون الإقبال الجماهيري على قراءة الروايات والسير الذاتية والترجمات مثلاً، فيسهمون في إبعاد الشعر عن تداولية يستحقها تاريخه وضرورته الإنسانية والجمالية.
لكن الجوهري في تشخيص راهن الشعر المتأزم يكمن في ما يحف بالكتابة الشعرية من ظروف ومحددات خارجية. فالوقع العنيف لما يحدث من حولنا منذ عقود، وتبدلات أولويات الحياة بسبب ذلك العنف، واكتظاظ اليوميات الإنسانية بالألم والعسف، وافتقاد أساسيات الحرية والعدالة والعيش الكريم، شكلت ما يسميه الوراري (نظرة الناس إلى الشعر في عالم لا شعري).
وتلك إشارة مهمة إلى مأزق تداولية الشعر في احتدام لا شعرية الحياة وثقلها وكثافة مفرداتها، وما تتسبب به من غربة وابتعاد للشعر كواحد من وسائل نجاة الفرد، والتوفر على توصيل معاناته التي يسودها نثر أكثر في غياب شعرية الحياة ذاتها، وتراجع الفنون المصاحبة والمعضدة للحالة الشعرية في الحياة اليومية كذلك، من إهمال الجوانب الفنية في البيوت والمدارس والفضاءات المدينية كالنحت والرسم والسينما والمسرح والمكتبات، واستبدالها ببدائل تناسب التواصل السطحي السائد، والصعود الشفاهي في علاقة الفنون بمتلقيها.
وهو ما توقعه المنظرون الأدبيون بصدد بروز شفاهية جديدة باسم التقدم التقني، حيث يعتمد الفرد على تلقيه لما يضخ له بصرياً عبر الشاشات دون أن يكون فاعلاً في عملية التلقي. وفي كتابته لمادة ما بعد الحداثة في موسوعة الأدب والنقد ينقل روبرت راي عن والتر أونغ قوله إن العصر الإلكتروني ربما يعادل (مرحلة ثانوية من الشفاهية) حيث يتم الاعتماد في التصور والفهم على المرويات الحكائية الملفوظة، والصور التوضيحية، ومغامرات الأبطال، بمصاحبة المؤثرات السمعية والبصرية التي (تأخذ بلبّ المتلقي وتسلبه قوة التركيز الذهني). هنا لا تحضر المدونات الكتابية مرجعاً للفهم والتصور، وتُنسى تماماً في ما يسميه (الاجتياح الثقافي الجديد) ما دعا بعض الفنون للجوء لتجريب بعض ما تمنحه المعطيات الإلكترونية لتناسب الوضع الفكري الجديد لعصر التلفزيون، وما يتداعى عنه من مؤثرات ومخترعات بصرية.
هكذا فعلت ما بعد الحداثة بالانتقال لشفاهية جديدة تبتعد بسببها نتاجات الكتابة عامة والشعر خاصة، كونه يعتمد الترابط اللغوي والبلاغة والتقريب التمثيلي للفكرة والصورة الشعرية. وهي انتقاله سرت عدواها للمتلقي العربي أيضاً لتزيد من عزلة الشعر في برنامجه الثقافي. فكان واضحا الانقلاب على الكتابة الشعرية والجهر بموت الشعر أو استنفاد جمالياته وتوقف مفعولها، بينما كانت الحداثة تلح في تمجيد المكتوب والتركيز عليه، والتأكيد على النظام اللغوي والفكري المرتبط بالكتابة كأبرز نقلة في حياة الإنسان الثقافية.
إن أثر ذلك الانحسار الشعري للحياة مهم في نقاشنا، ليس بمعنى ضعف الإقبال على قراءة الشعر وحسب، بل غياب ظواهر كثيرة لها صلة بالتكوين الشعري للفرد والتهيئة لتقبله الملفوظ الشعري وحداثته بشكل خاص.
بجانب عودة الشفاهية للخطاب الشعري والمتمثلة ببروز الشعر الجماهيري الخطابي وإحياء الصلة الشفاهية في تلقي الشعر سمعياً عبر المنابر والخطابة، وهو ما يتطلب العودة لفنون شعرية تجاوزتها الحداثة في الكتابة الشعرية. وكذلك حركات التجديد في الشعر العربي نفسه. فشاعت القصائد التقليدية التي تعتمد الضجيج الصوتي، والتأثير في متلقٍ (سمعي) يفهم البيت الشعري بما تسمح به قابلية الأذن واستيعابها الصوتي، بديلاً عن (قارئ) مفترَض يمسح النص الشعري بعينيه قارئاً متتبعا لهيئة النص الخطّية، ولتحولاته الإيقاعية والصورية والدلالية التي لا يحصرها بيت واحد بل وجود كلي في وحدة النص.
يقابل ذلك سلباً صعود الشعر الجماهيري المنبري والخطابي. وهو علامة على تعثر مشروع التحديث بالاحتكام إلى الوقائع الخارجية، والعمل على إحياء خطاب المباشرة والتقريرية والغنائية الزاعقة. والعودة تراجعاً إلى صلة الشعر آلياً بالجمهور وقضايا الناس التي لا يتجاهلها خطاب الحداثة الشعرية، بل يعلي شأنها بفنية متنوعة الرؤى ومتجددة الأساليب. ما يتطلب تأهيل القراء أيضاً. وترقية (ثقافتهم الشعرية) لتلقي النصوص الحديثة. تلك الثقافة الشعرية العربية التي أشارت إليها الزميلة هدى فخر الدين في إجابتها على تساؤلات التحقيق المنشور، منوِّهة بالقوة الفكرية للشعر، وصلته باللغة التي تقوى بالشعر وتتجدد.
لا أبغي هنا التصويت على (كل) ما يُكتب تحت لافتة الحداثة الشعرية. فثمة ضعف حتى في النصوص المكتوبة تحت مسمى قصيدة النثر، كما هو في الأنواع الشعرية الأخرى، وثمة رغبة في التماثل الصوتي، والحماسة للشكل، واحتذاء التجارب الجاهزة.
ومادام الشعر بديهياً، سابقاً على النقد فإن الأخير يستمد حداثته من الأول، وتكون حداثة الشعر ضرورية لحداثة النقد وتجدده المنهجي المطلوب لعلاج أزمته وتَراجع حضوره بالضرورة.
فالأمر ذاته حاضر في الكتابة النقدية، كالتخبط المنهجي، والنقل دون تكييف مناسب للنص العربي، وسيادة الاتجاهات المضمونية، وغياب الهاجس النظري للحداثة الشعرية، وبعض المعوقات التواصلية، والاستجابات اللانصية، وكلها تعطي ملْمحاً يسمح لنا باقتراح المراجعة الدائمة، والبحث في الممارسة النقدية، وتلمُّس ما تعانيه، ولكن بالحفاظ على وجود النقد ظاهرة حضارية وثقافية وحاجة جمالية تدعم فكرة القراءة، ويوازيها التمسك بالشعر وسيلة وغاية لحياة الإنسان ومستقبله.
إن الاستطراد السابق ضروري لإشباع طرف الثنائية الآخر الذي قد يغيب عن التلقي بسبب العنونة التي ركزت في التحقيق المنشور على (تراجع نقد الشعر..). وقد عزاه الشاعر والناقد منصف الوهايبي – وهذا ما يجعل شهادته ذات ميزة إضافية – إلى الخلط بين الباحث والناقد. وهو بذلك يشير إلى جمود الكتابة الأكاديمية المنشغلة بمتطلبات روتينية لحد ما، والمحتكمة لمحددات لا يخضع لها الناقد. ويقوي من وجهة نظره ما نراه من تهافت أو ضعف الرسائل الجامعية، وهامشية موضوعاتها التي تأخذ غالباً لافتات مقتطعة من منهجيات حديثة لتسوِّقها للدارسين وإسقاطها على نصوص ضعيفة وتجارب محدودة غالباً، وبمنهجيات ملصقة من دون استيعاب خطواتها واستراتيجياتها.
كما شاع مؤخراً البحث عن الأنساق الفاعلة في الشعر، فصار ذلك عنواناً لمئات الرسائل التي تتخذ من تجارب هامشية وغير ناضجة أحياناً ميداناً لتطبيق المقولات التي جاءت بها النسخة العربية من النقد الثقافي وضخمتها، مغفلة النسق العام المتحكم في الكتابة الشعرية ذاتها، ومغفلة كذلك موقع الشاعر في عصره أو مرجعياته الثقافية الخاصة، وما يحيط بإنتاج نصه من مؤثرات وعوامل وظروف.
لقد وددت أن يشير الزملاء – وقد وصفهم الوراري بالأوفياء لدرس الشعر- إلى ما يفعله نوعان من الانقلاب على النقد الأدبي، ونقد الشعر من ضمنه حتماً. وهما: القول بأن الزمن هو زمن الرواية وتراجع الشعر وموته. والثاني المتمثل بالنقد الثقافي المتراجع للخطاب الإيديولوجي والقضايا الاجتماعية، ومحاكمة النيات والافتراضات الفكرية، بدون الالتفات إلى ما ذكرته هدى فخر الدين وما ركزت عليه دراسات الشعرية لاسيما البنيوية منها، حين أكّدت في إجابتها على أن النقد يظل قاصراً وسطحياً إذا ظل معنياً (بما) يقوله الشعر لا (كيف يقوله).
وتشير لموضوعات الشعر فترى أن القضايا الكبرى لا تصنع شعراً إلا (بالإخلاص الفني لها) وعدم الاتكاء على موضعها مهما كان نبيلاً لتخفي ضعفها. وكأنها تذكرنا بشعر المقاومة الفلسطينية في مراحله الأولى حيث قوبل بمحبة عارمة من دون الالتفات لفنيته، ما جعل شاعراً مهتماً بفن الشعر ذاته كمحمود درويش إلى إطلاق صرخته المعروفة: (أنقذونا من هذا الحب القاسي) مطالباً (بمعاملة الشعر على أنه شعر… والتأكيد على استخدام المعايير الفنية لا السياسية) وحدها في قراءته ونقده.
وبموازاة ذلك تنتفض حورية الخمليشي لنبذ (القراءة العاشقة) ورفضها، لأنها (لم تعد كافية لقراءة النص الشعري.. الذي يقتضي قراءة عالمة ومبدعة..). وأظنها تزيح القراءات الانطباعية وما تحمله من عواطف رضا أو انزعاج، وتنشد بدلاً عنها قراءة منهجية ورؤية عارفة. وذلك يستلزم توسيع أفق النقاد الأكاديميين ليخرجوا، كما تقول، إلى (شعرية الانفتاح) وبأكثر من اتجاه: الانفتاح على الفنون الأخرى وعلى ما هو خارج أسوار الدرس الأكاديمي، والخلاص مما أسماه الوهايبي (ارتباك) المنظومة التعليمية، داعياً إلى (القراءة) لتحل محل النقد الذي يرى أنه غاب أو كاد.
وهي دعوة زئبقية لحد ما، إذ النقد اليوم ضرب من القراءة الفاعلة لا المنفعلة. وهي بالضرورة تشتمل على خطوات وإجراءات، وتستخدم سبلاً من النقد لا من سواه، فهي ترادف النقد ولا تنوب عنه.
لقد أشرت في إجابتي المنشورة على ضرورة التركيز نقدياً على أدبية النقد. فهو أدب قبل أي وصف، موضوعه وأسلوبه ومكمن رؤيته أدبية، وهذا يجعل حضوره في القراءة الشعرية لازماً وضرورياً.
وسوف تغنينا دراسات الدلالة وتشكلاتها في القصيدة عن افتراضات خارجية غير نصيّة مسقطةٍ قسراً على النصوص. ونحن لا ننفي الحمولة الاجتماعية والعقائدية والمواقف والرؤى التي تزخر بها النصوص متخفية في إشارات ورموز، أو مصرّح بها، وتتعهد القراءة بزخم طاقة التأويل والشرح والفهم أن تستجليها، وتقربّها للقارئ لتشركه في اكتشافها، أو بناء موقف قرائي على أساسها.
بإيجاز شديد أجد أن بنا حاجة للتواضع على مسلمات أولية بين الشعراء ونقاد الشعر. ومنها التركيز على (أدبية) الخطاب الشعري، وتعقبه لما يُنشر بمسمى الفن الشعري داخل القصيدة ذاتها أولاً، وليس خارجها، بافتراض أنساق صغرى وتأويلها سلبياً للتزهيد بالقول الشعري، أو القراءة الموضوعاتية الشارحة والمتمددة من المعاني فقط. وكذلك يجدر بنا التأكيد على عدّ النقد ضرورة حضارية، وإن رفضه وتصغيره وتغييبه، حتى بدواعي ضعف راهنه وحاضره، ليست إلا عودة للبداهة والشفاهية، والتمركز الذاتي للمبدع في نصه الذي لا يرى سلطة أعلى منه، جديرة بفحصه وقراءته، إلا بما يوافق هواه ونيته، وما يرغب أن يقال عنه.