مغامرة التعرّف واكتشاف الذات: توافقات الأسفار
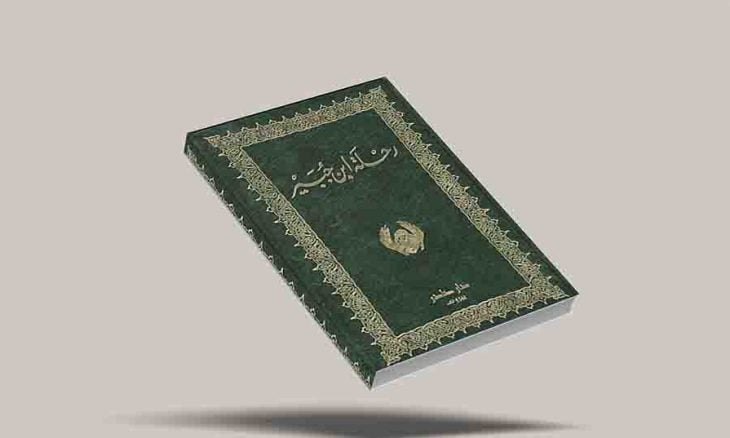
حاتم الصكر
يتحدث محمد بن جبير عما يسميه (اتفاقات الأسفار) في مذكراته عن رحلته الأولى لمصر والجزيرة والعراق والشام وصقلية التي بدأها من غرناطة عام 578 هجرية الموافق للعام الميلادي 1183.
يبدأ المخطوط الذي ضم وقائع رحلته ومرائيها بعنوان «تذكرة بالأخبارعن اتفاقات الأسفار»، مهيئا القارئ لتسلم يوميات مؤرخة ومدوَّنة في حال حدوثها، معلناً عن طبيعة مادتها الخبرية، ومنوهاً بما تحمل الأسفار من مصادفات، نظراً لدورها في فعل السفر والرحلة، وفي تفاصيلها وسياقاتها، فوصفَها بالاتفاقات، أي ما يقع عرَضاً ومصادفةً كتوافقات ذات مُشغّل قدَريٍّ أحياناً.
لقد كان ابن جبير واحداً من الرحالة الشبيهين بعدّائي المسافات الطويلة في رحلتهم، قياساً للسفر القصير الذي يقوم به السائح أو الضيف أو المسافر أو التاجر. وكان ذلك دأْب الرحالة المغاربة في رحلات الحج التي ينتهزونها للطواف في الآفاق التي تتيحها المسافات براً وبحرا، فتستغرقهم لأشهر، وتمتد رحلاتهم لسنوات.
من هنا تكون للمصادفات قوة الفعل المحدِّد للوجهة والسياق الرحلي المتضمن التعرف كهدف ذي نوعىة إنسانية، واستكشاف مفردات المكان، ووصفه بدقة تبلغ أحياناً ما تحمله الوثيقة أو الصورة.
وتكون عائدية نص الرحلة بهذا الأسلوب إلى صاحبها. فتُسنِد إليه حتى يُنسى العنوان غالباً، كما حصل مع رحلة ابن بطوطة أيضاً «تُحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، فقد أُسندت إليه في التداول اختصاراً، وكاد عنوانها أن يُنسى.
وتهمّنا هنا الميزة الأدبية لنصوص الرحلة. فهي تتجاوز هدفها التعرفي والاستكشافي فضولاً ومغامرة، لتؤدي مهمتها الأسلوبية، فيعكف الرحالة في نصوصهم ومدوناتهم على اتباع بلاغات عصورهم وأساليبها النثرية. وهذا يفسر تلك النصوص التي تقطع سياق التعرف المجرد كوصف المكان والجماعة البشرية ومرائي العمران والطبيعة، لتنتبه إلى لغتها وصورها وبديع أوصافها التي يراد لها أن تتسق أو تتوافق مع المرائي الغريبة والمدهشة التي يحرص على اقتناصها الرحالة ويضمنونها في مدوناتهم ومذكراتهم.
لا يستمع الرحّالة إلى النواهي المحذِّرة من السفر. فابن جبير مثلاً يذكر عدة مواقف لتوافقات سيئة، عصفت خلالها الرياح، وهاج البحر، وتمزقت أشرعة السفن، وأوشك المسافرون على الغرق. لكنه يعود للوصف متوقفاً عند جماليات الصور البصرية الناقلة للدهشة والغرابة التي تقرّب نص الرحلة من العجائبي والغرائبي الذي يرد في السرد الخيالي أحياناً. وهو ما يرشَح في عناوين الرحلات ذاتها، وتعمل اللغة بطاقةٍ واضحة في تصوير المشاهد الغريبة والوقائع المدوية، فيغيب الاسترسال ويعلو السجع، وكأنه نشيج أو ندب. كما حصل في تصوير ابن جبير لما وافقهم من اشتداد الريح والموج واشرافهم على الغرق «.. حتى ضربت في وجوهنا ريحٌ أنكصتنا على الأعقاب، وحالت بين الأبصار والارتياب. وما زالت تعصف، حتى كادت تنسف وتقصف. فحطَّت الشّرع عن صواريها، واستسلمت النفوس لباريها، وتركنا بين السفينة ومجريها، وتتابعت علينا عواريضُ دِيَم، حصلنا منها ومن الليل والبحر في ثلاث ظُلم…. فنبذت نفوسنا كلّ أمنية، وتأهبت للقاء المنية..». لكن الاتفاقات لا تخلو من أخبار سارة، كما حصل لابن جبير وزميل رحلته قريباً من عودتهما لغرناطة، حين التقيا بعد انتظار ورهبة، وفي (اتفاق عجيب) حجّاجاً مغاربة، فيهم جماعة من أهل غرناطة «فكان يوماً مشهوداً، اتخذناه عقب العيد عيداً جديداً..».
لا تخلو تذكرة ابن جبير مما يمكن أن يكون صوراً نمطية عن طبائع البشر كحديثه عن السودان مثلاً وعن الناس ببغداد، وهو لم يُقم إلا زمناً قصيراً، مما لا يمكن عدّه تعرفاً وتثاقفاً صحيحاً، بل هو إلى الانطباع أقرب، وشبيهٌ بالحكم على حالة وتعميمها. لكنها في النهاية رؤية الرحالة وانفعالاته وردود أفعاله على ما يحصل ساعة تدوينه للواقعة. وتتضح نهاية المشقة والعناء في إعلان الفرح والبهجة بالعودة للوطن. وكأن الرحالة يعترفون بأن ما يحصل في نصوصهم الرحلية وصفيٌّ وخارجي، لا تغيب فيه أوطانهم من ذاكراتهم، وتكون تلك أمكنة غريبة عنهم. فيذكر ابن جبير بيتاً شعرياً في صفحة تذكرته الأخيرة، بعد الوصول إلى المنزل بغرناطة، يدل على فرحة الإياب ولذة الاستقرار:
فألقتْ عصاها واستقرَّ بها النوى كما قرَّعيناً بالإياب المسافرُ
2
تتبخر إذن مقولات الفوائد السبع للأسفار، ويحل محلها مثلث رحلي جديد: الهدف البعيد، ووحشة المكان، ومخاطر الطريق.
يزودنا الشعر العربي بدواعٍ عدة للسفر. يدشنها أبو تمام الذي يضيق بالمقام والاستقرار، ويراه عاملاً مهلكا للجدة والتجدد. ويلخص حكمته بالقول (فاغترب تتجدد). ويأخذ من خزينه الحكمي ما يهديه للمغترب: إنه مثال من الطبيعة.
الشمس محبوبة مطلوبة لأنها تغيب، ولا تلبث دوماً:
وطولُ مقام المرء في الحي مخلقٌ لِديباجتيهِ، فاغتربْ تتجددِ
فإني رأيت الشمسَ زيدتْ محبةً إلى الناس، أن ليستْ عليهم بسرمدِ
ويتلقف المتنبي بعده تلك الفكرة فيضعها في إطار الاختيارات، ويرى أن الممدوحين يعيقون حركته في (الترحال والتنقل)، ويمنعون عنه عند ضجرِه رغبتَه بالمغادرة، فيُضطر إلى مفارقتهم (على أقبح الوجوه). وينشد في شعره أن يكون طليقاً في الفلاة وهجيرها:
ذراني والفلاةَ بلا دليلٍ ووجهي والهجير بلا لثامِ
فإني أستريح بذي وهذا وأتعب بالإناخة والمقامِ
ولمن حسب فوائد السفر خمساً وجدها في شعر منسوب للشافعي، وهي:
فتفريجُ همٍّ، واكتسابُ معيشةٍ وعلمٌ، وآدابٌ، وصحبةُ ماجدِ
وكلها بحاجةٍ للتيقن واطراد الحدوث. وهو ما لا يثبته فعل السفر استقراءً. بل نجد المفارقة في أن كاتب «الرحلة الحجازية» محمد بن الطيب الفاسيّ وهو من الرحالة المتأخرين، يورد ما ينسب للأسفار من خسائر أو (عوائق) كما يسميها، اقتبسها من أبيات للقاضي عياض:
تشوُّقُ إخوانٍ، وفقدُ أحبةٍ، وأعظمها يا صاح سُكنى الفنادقِ
وكثرةُ إيحاشٍ، وقلةُ مؤنسٍ، وتبديدُ أموالٍ، وخيفةُ سارقِ
ثم يعلق ابن الطيب بعد ذكرها بأنها (لا يعوّل عليها ومردود عليها بما مرَّ من مزايا السف)، مذكراً بما قاله هو من نظمٍ في الفوائد المنسوبة للسفر والحث على الرحلة والتطواف في الأرض «لأنّ في السفر الظفر» كما يقول ناصحا، مضيفا أن «المكثَ في الأوطان يدعو للضجر». أمّا تشوق الأهل والأصحاب فهناك ما يعوض عنهما:
لا تبكِ إلفاً لا ولاداراً، ولا رسماً دثرْ
فالناس إلفُك كلّهم، والأرضُ أجمعُها مقرْ
وقد وجدتُ في أبياته تنويعا لفكرة السفر، حيث تتسع دائرة الأخوة الإنسانية، وتصبح الأرض كوكبا مشتركا يسكنه البشر بلا تمييز، لكن القارئ المعاصر يتساءل عن إمكان ذلك واقعاً، في صعود الكراهية والخوف من الآخر، مما تعطيك براهينه ما تحفل به المطارات والموانئ والمنافذ من عقبات ومعوقات، تضاهي تلك الأهوال التي تحدث عنها رحالة العصور السالفة.
وثمة مفارقة يجدر بنا ذكرها، فقد تعرَّض مؤلف «الرحلة الحجازية» نفسه لواحدة مما ذكره القاضي عياض، حيث جرده اللصوص من أمواله، وسلبوه مذكراته حول الأماكن التي مر بها، وعدداً من قصائده التي يتحسر على فقْدها، قائلا عن إحداها إنها «كانت أزيد من ثلاثين بيتا اختطفتها يد السارق، وترك القلب من أجلها محارق». ويذكر ذلك مرات عدة في رحلته «وكنا جمعنا في طريقنا نبذةً تحتوي على ما سلكناه من المراحل.. وفي ضمن ذلك أبيات كان يقتضيها الحال، وقصائد شرفناها بذكر تلك المحال. فاستولت على ذلك كله يد الضياع، وسرقها سارق مع ما كان من كتبٍ ومتاعْ.
فيا ليته لو ردَّ منها قصيدةً وسامحْتُه في المال أجمع والكتبِ».
ولكنه بعد ذلك كله يواصل رحلته ويكررها ثانية، وكأنه يذكرنا بالسندباد. الذي كلما عاد من سفر تعرض فيه للخطر، راودته نفسه (الأمّارة بالأسفار) كما يرد في الليالي من رحلاته السبع:
«.. وقلت لروحي يا سندباد يا بحري: أنت لم تتبْ. وكل مرة تقاسي فيها الشدائد والتعب. ولم تتب عن سفر البحر. وإن تتبْ تكذبْ في التوبة. فقاسِ كل ما تلقاه. فإنك تستحق جميع ما يحصل لك…».
وتقترن الأهوال برحلات الأسطورة أيضاً. وتكون الريادة فيها لملحمة جلجامش في الأدب الرافديني. فبناءً على ما في نص الرحلة من تعويض ومكافآت تمنحها اتفاقات الأسفار، يحصل جلجامش على رحلة محفوفة بالأهوال تقوده إلى الأعماق حيث اللجة، وأوتونيشتم الجد الذي يسعف طلب جلجامش بالبقاء الأبدي. ويمنحه أخيراً عشبة الخلود التي سيفقدها، وهو مستريح على حد البر الذي خرج إليه من الظلمات. ثم سيمنحه القدر الهبةَ بشكل حكمة تالية، ستكون تعلةً له ودرساً إنسانياً، مؤداه: أن الخلود الممكن البديل لا يكون إلا عبر الأعمال الباقية.
وفي شخصيات جلجامش وعوليس والسندباد نجد توافقات سردية ترسم أبعاد الشخصيات وتصمم رحلاتهم، وتتعقب الهدف والوسيلة والسياق التوافقي المبرر لمفاجآت الوقائع، والغريب والعجيب في مفردات السرد. وربما كان لعوليس هدف أكثر وضوحاً وأرضية من صاحبيْه، فهو متجه لإيثاكا الوطن، وبنلوب الزوجة. كان عائدا يتبع سهم رغبته المؤشر إلى موطنه، وحيث بنلوب تحوك صوف الانتظار أملاً بمَقدَمِه، مُبعدةً خُطّابَها بوعد زواجها منهم، بعد الانتهاء من غزْل صوفها الذي تنفضه كل ليلة.
3
في عدد مكرس للسياحة وأدب الرحلات من مجلة «فكر وفن»، هو العدد التاسع والثمانون لعام 2008، يكتب الشاعر الألماني هانس أنسنسبرغر مقالاً عن «الحنين الرومانسي للبعاد وإحباطاته»، متحدثاً عن السفر كفعل لازم، ليس لغرض التجارة كما في متون الرحالة الأوائل، مقرراً أن السفر من أجل السفر ينطوي على المغامرة. ويرى أن «الحنين المشبوب للبعاد ضرب من الرومانسية»، مذكراً بأن كثيراً من الأسفار تتم بسب الهروب من واقع ما، وتلبية لنداءات المخيلة عن الحرية واختراق المألوف. وكأنه بهذا التشخيص يذكرنا بما في التراث الإنساني من رحلات خارقة، ترمزت أدبياً وتم تمثل خيالاتها سردياً. ولابد هنا من تذكر «رسالة الغفران» للمعري، و«الكوميدا الإلهية» لدانتي. فهما رحلتان رمزيتان في الفضاء السردي، لكنهما يعبّران كمتون ماثلة للقراءة، عن هدف غير بعيد عن إيديولوجيا اعتقادية، تعمل بشدة لتوصيل خطابها عبر تلك المفردات السردية، وبالعبور لعالم افتراضي آخر، وتطعيم الأحداث بشخصيات ووقائع وأحداث من الواقع. كان المعري يريد تبرئة مجازات الشعراء وتلفظاتهم من التفسير النثري لها، فتصبح بعد نزْع غلافها المجازي والخيالي مقولاتٍ محظورةً. ويبحث المعري في حلم طويل مفتعل عن أعذار توجب الغفران لهؤلاء الشعراء والأشخاص، ويجيب على سؤال ابن القارح عن حقيقة كفرهم. ويتخذ دانتي في رحلته خطوات دقيقة لتعريف البشر بما صنعته أنفسهم بهم من شر، وما لحق بأرواحهم من ضرٍّ. ويختار الأمكنة التي تمثل ذلك، ويقدم رؤياه مستوحياً ما في الدين من منطق وأقيسة، ومسقطاً ذلك على البشر والجماعات.
يكون لفعل السفر من أجل السفر غايات منزهة عن المحمول المسبق. تتهيأ ذات الرحالة لغرض السفر لتلقي المفاجئ القادم من توافقات، تعرض لها ابن جبير، ولم تغب عن خاطر الغربيين أيضاً. لكن التعرف كوازع سخيفف تلك العوارض والصعاب.
اكتشاف الآخر ومعرفة الذات هدفان للرحلة كما تلخص إحدى الدراسات في عدد «فكر وفن» في عنوانها، مشيرة إلى ما قام به الرحالة العرب إلى أوروبا ووضعوه في المتن الرحلي أدباً، سيدخل في تصنيف الأنواع الأدبية، ويأخذ مكانه فرعاً حياً في شجرة الأدب الوارفة.
المصدر: القدس العربي
تقرير متلفز لـ"وول ستريت جورنال" عن تصاعد خطورة #البحر_الأحمر على الملاحة الدولية وتأثير هجمات الحوثيين اقتصادياً وعسكرياً على المنطقة والعالم #يمن_مونيتور #اليمن #yemen pic.twitter.com/YXhjyPuoWq
— يمن مونيتور (@YeMonitor) June 23, 2024





